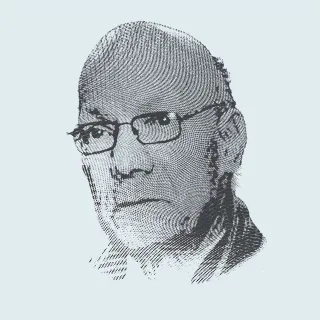لا أظن أننا كنا في حاجة للثقافة كما نحن في حاجة إليها الآن. ولا أظن أن ثقافتنا مرت بمرحلة من التراجع كما تراجعت في هذه الأيام، بحيث لم تعد قادرة على أن تؤدي دورها الذي كانت تؤديه من قبل، فهي الأخرى في أشد الحاجة إلينا لتسترد عافيتها، كما أننا في أشد الحاجة إليها لنسترد شعورنا بوجودنا، وثقتنا في أنفسنا، وقدرتنا على مواجهة ما نواجهه من تحديات.
ومن الواضح أن الثقافة التي أتحدث عنها في هذه المقالة هي ثقافتنا العربية الجامعة التي لا بد أن نميز فيها بين ما ورثناه من التراث العربي القديم وبين ما اكتسبناه في هذا العصر الحديث، سواء ما أنتجناه بطاقاتنا الذاتية أو ما نقلناه عن الآخرين. ولا شك أنهما طوران في ثقافتنا القومية مختلفان إلى حد كبير.
في الطور الأول، أي في القرون التي تلت ظهور الإسلام، لم تكن لنا ثقافة جامعة، وإنما كانت لنا ثقافاتنا المحلية المختلفة الموروثة من تاريخنا السابق على الإسلام. وقد ظلت هذه الثقافات المحلية حية طوال القرون التي كان لا بد أن تمر قبل أن ينتشر بيننا الإسلام ونتعرب ونصبح قادرين على المشاركة في إنتاج ثقافة عربية جامعة. وهو دور بدأناه منذ عدة قرون، لكنه لم ينضج ولم يصل إلى غايته إلا في هذا العصر الحديث الذي أصبحت فيه الثقافة العربية ثقافة قومية نشارك جميعاً فيها بإنتاج جديد كان لا بد أن يختلف عما كانت عليه الثقافة العربية في عصورها الأولى، خاصة حين نتوسع في فهمنا لمعنى الثقافة، فلا نحصرها في الإنتاج الأدبي والفكري الموروث، بل ندخل فيها كل ما يحيا به المجتمع ويحتاج إليه من أدوات الاتصال، وأشكال التعبير، ومن الأفكار والقيم والقوانين والنظم التي تجسد شخصيته، وتحدد سلوكه. وإذا كانت الثقافة القومية تجمع هذه المفردات وتطبعها بما يؤلف بينها ويعبر عن شخصيتها فلا شك أن لكل مجتمع ثقافة، ولكل عصر ثقافة، خاصة إذا كنا نتحدث عن ثقافة امتد وجودها في الزمان والمكان من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الحادي والعشرين، ومن الخليج إلى المحيط.
هذا الوجود الممتد في الزمان والمكان كان من شأنه أن ينتج صوراً متعددة من الثقافة. وهذا ما حدث فعلاً. لكنه أنتج مع هذه الصور المتعددة صورة جامعة مشتركة ظلت حية، وظلت قادرة على أن تستجيب لحاجات المجتمع، خاصة في هذا العصر الحديث الذي انفتحت فيه بلادنا على العالم وتأثرت بأحداثه وبما ظهر فيه من كشوف علمية، واجتهادات فكرية، وأشكال مختلفة وأطوار متعددة في الآداب والفنون. والثقافة العربية بصورها المحلية المتعددة وصورتها القومية الجامعة تعبر عن الواقع الذي عشناه ونعيشه، فليس لأي من الصورتين أن تنفي الأخرى. لأننا في حياتنا اليومية ونشاطنا العملي نحتاج لثقافة، وفي نشاطنا العلمي وإنتاجنا الأدبي والفكري نحتاج لثقافة أو لصورة أخرى من هذه الثقافة.
ومن الطبيعي أن تكون اللهجات المحلية المختلفة هي وسيلة التواصل بين أفراد المجتمع في الأقطار العربية، وأن تكون الأعمال الأدبية والفنية التي تُستخدم فيها هذه اللهجات في الغناء، والمسرح، والسينما شائعة منتشرة. وهذه مسألة أُثيرت في مصر وأثيرت في لبنان وربما أثيرت في أقطار أخرى. ولهذا تحتاج لتوضيح؛ لأن معظمنا يكتفي فيها بنظرة عابرة، أو بفكرة شائعة لا يمتحنها ليميز فيها بين الصواب والخطأ.
***
بعض المتعصبين للفصحى يظنون أن استعمال العامية ينال من قدر الفصحى. ومثلهم المتعصبون للعامية الذين يطالبون بالتخلي عن الفصحى ما دامت لا تستخدم في التفاهم والاتصال، والاكتفاء بالعامية التي يمكن في رأيهم أن تستخدم في كل المجالات كما فعل الأوروبيون حين تخلوا عن اللاتينية وأحلّوا لهجاتهم المحلية محلها.
وهذا تفكير قاصر لا معنى له إلا الاكتفاء بالقليل والاستغناء به عما ادخرناه طوال العصور الماضية من ثروات ثقافية، فضلاً عن وجود اعتبارات أخرى لا يمكن معها التخلي عن الفصحى، ومنها الاعتبارات الدينية التي لا يستطيع معها العربي المسلم أن يستغني عن الفصحى كما استطاع الأوروبي الكاثوليكي أن يستغني عن اللاتينية.
والذين يضيقون بوجود العامية مع الفصحى أو بوجود الفصحى مع العامية يظنون أن هذا الوضع غير موجود إلا عندنا. وهذا وهم أشاعه بعضهم في أوساط الشباب المثقف، لكنه لم يفلح في إحلال إحدى اللهجتين محل الأخرى، وإن أفلح في إشاعة مناخ عام لا يعبأ باللغة في كل مستوياتها. فهو في الفصحى لا يعرف النحو، ولا يخجل من الوقوع في الخطأ، ليس في الحديث فحسب، بل في التأليف والكتابة أيضاً. وذلك لأن البلادة التي تبدأ باللغة تنتقل إلى التفكير. فنحن نفكر باللغة. وحين نجهل اللغة ونسيء استخدامها، ونفسدها بما نقع فيه من أخطاء نعجز عن التفكير المنطقي الواضح، ونثرثر في التفكير كما نثرثر في التعبير.
***
لكن دفاعنا عن الفصحى ودعوتنا لاحترامها والتمكن منها لا يصح أن يكون هجوماً على العامية أو دعوة للتخلص منها. فالعاميات العربية حقيقة واقعة في كل أقطارنا مثلها مثل الفصحى، وهي حاجة لا يمكن الاستغناء عنها. وليست هناك ضرورة تحتم ذلك. والذين يعرفون اللغة يعرفون أن العامية ليست مرضاً أصيبت به الفصحى في العصور الأخيرة كما يظن كثيرون، وإنما العامية لهجات عربية قديمة لم تتح لها الثقافة التي أتيحت للفصحى لغة قريش. ونحن نرى أن الفصحى حين تنهض وتزدهر تنهض العامية وتزدهر. والعكس صحيح. وما علينا إلا أن نقارن بين ما كانت عليه العامية المصرية على لسان بيرم التونسي، وشوقي في أغانيه، ورامي حتى وصلت إلى صلاح جاهين، وفؤاد حداد. ونرى أن تراجع الفصحى في هذه الأيام لم يقتصر عليها، وإنما امتد إلى العامية كذلك. وما علينا إلا أن ننظر في أغاني هذه الأيام!
وللحديث بقية.