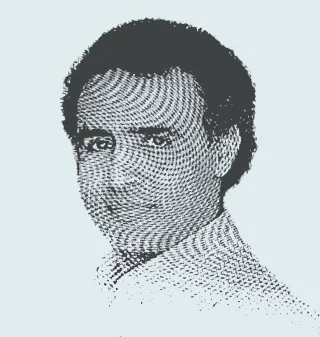غرض النضال يبرر لأصحابه سلوكيات ينأى عنها المواطن العادي الذي لا يرى نفسه سوى شبيه بالأشباه، ونظير للأنظار، ليس متفضلاً عليهم بتضحية لم يطلبوها، ولا يدعي علماً يفوق علمهم، ولا يمنح نفسه موقع القائد بينهم.
أسوأ سلوكيات ذلك المناضل أثراً الكذب تحقيقاً لغاية «نبيلة»، وإطلاق الأحكام على الآخرين، واغتيالهم معنوياً وشخصياً. ومن يعتمد الكذب لتوصيل فكرة يفقد فوراً الاتساق والنزاهة، وهما تاج رأس المثقف. من مثقفينا هؤلاء من أحب نسخته الحالية، لكنني أمقت المقت كله نسخته السابقة. والفارق بينهما تخليه عن شخصية المناضل، وغطرسته، ولفه ودورانه، وتقعره عن التفكير المستقيم المباشر.
سمعت التسجيلات الأخيرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفكرت فوراً في أنور السادات. كيف أحيط في بداية حكمه بشلة من هؤلاء المناضلين، بين سياسيين ومثقفين، ألبوا عليه واتهموه بالخيانة، ودعوا صراحة لقتله، ثم تباهوا بذلك حين حدث. لنكتشف أنه كان الصادق الوحيد بينهم.
لا شك أن هؤلاء، لا سيما القريبون من دوائر الحكم في الستينات، علموا أن النظام في مصر قبل بالمسار السلمي خياراً استراتيجياً. أن جمال عبد الناصر أبلغ من حوله، بعد كارثة النكسة، أن مصر تعتزم المضي في ذلك الطريق، وأنه تعلم بالخبرة أن الأنظمة العروبية والبعثية تعتزم التضحية بآخر جندي مصري. علموا من ثم أن أنور السادات في هذا الجانب من القرار السياسي لم يأتِ بجديد، ولا خان عهداً. أنه كان شجاعاً، مضحياً، ناكراً للذات، منجزاً، في غلالة من الدهاء والكاريزما. استطاع في ثلاث سنوات فقط أن ينقل مصر من موقع إلى موقع. فكان مستحقاً للمديح والتمجيد لا التخوين والاغتيال.
في مقابل نكرانه للذات، تعامل حملة قميص ناصر مع السادات وكأنهم أولياء الدم. وهو نهج اضطر السادات من البداية إلى أكبر أخطائه. وجد نفسه بلا ظهير شعبي وطلابي، فلجأ إلى الإسلامجية طلباً لهذا المدد.
الآن، تمعنوا في المفارقة. لامته جماعات اليسار على ذلك الخيار الذي دفعته إليه دفعاً، لكنها تحالفت مع الإسلامجية، بالصوت والصورة، بالغناء والموسيقى، بالدعاية والنكاية، على غرض التخلص منه. ولا سيما بعد معاهدة السلام.
كذبت جماعات اليسار إذن في مسار السلام، وتخابثت في مسار التعامل مع التطرف الديني. والنتيجة أننا خسرنا على الوجهين: خسرنا رجل الحرب والسلام بالاغتيال، وخسرنا حياتنا بالعيش تحت سيطرة التطرف. وخسرنا في نخبتنا الشجاعة والنزاهة والمَثَل. والأمم إن خسرت الشجاعة صار أكبر أمانيها تحجيم السقوط بدلاً من المغامرة من أجل النجاح.
امتدت الناصرية إلى أبعد من عبد الناصر بكل أخطائه. صارت الناصرية اسماً كودياً لنظرة إلى الحياة العامة، يتفق عليها قطاع واسع من البشر. حين تنزع المفردات الدينية عن الإسلامجي يتحول فوراً إلى ناصري، وحين تضيف المفردات الدينية إلى اليساري والبعثي والعروبي يتحول فوراً إلى إسلامجي. كلاهما يعتقد أنه يملك الحق المطلق، المستعلي على من حوله. كلاهما يعتقد أن الصراع أفضل جوهرياً من السلام. كلاهما يحب السيطرة ويتغزل بالحرب. لا يختلفان إلا على مساحة السيطرة.
وكلاهما لا يدرك قيمة القيمة، ولا منشأها ولا غرضها. هذا جوهر قدرتهم العجيبة على تدمير الخارج والداخل. مَن يدري ربما أوشك عبد الناصر أيضاً على الانفتاح لإنقاذ اقتصاد البلد. ربما فهم بالتجربة لماذا نرسم العدالة عمياء. لا فرق لديها بين مَن يملك ملايين ومَن لا يملك. ربما فهم أنها قيمة مختلفة عن الرحمة والصدقة والعطف. أن انحياز العدالة نحو الغني فساد، وانحيازها نحو الفقير فساد. انحيازها نحو المالك فساد، ونحو المستأجر فساد. بالمصادفة، لا نزال بعد أكثر من نصف قرن على وفاته لا نستطيع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من قوانينها الثورية الجائرة. على ما تسببت فيه من إفساد للاقتصاد وتدهور في حال البنايات القديمة، بين مالك يشعر نحوها بالمرارة، ومستأجر لا يعنيه تطويرها.
تسجيلات عبد الناصر المنشورة مؤخراً دليل إدانة على رافعي قميص عبد الناصر طوال نصف قرن. وهي إعادة اعتبار للسادات، ولعشرات الكتاب والمثقفين الذين كانوا صادقين معنا، فعاشوا في ضنك من تشويه دوائر الثقافة لهم، وأغمطوا حقوقهم. لولا موهبة نجيب محفوظ الطاغية لكان واحداً منهم. هؤلاء هم الدليل الحي على أن ما انكشف من تسجيلات عبد الناصر ظل مدفوناً بفعل فاعل.