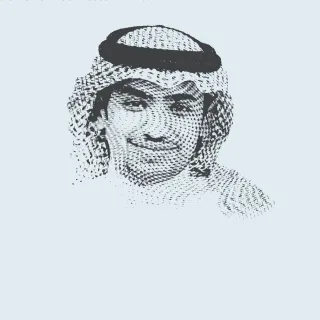قدّم صموئيل هنتنغتون – صاحب أطروحة «صدام الحضارات» – في مطلع تسعينات القرن الماضي صياغته النظرية لـ«الموجة الثالثة في التحوّل الديمقراطي»، مُفترضاً أنّ الانتقال من النُّظم غير الديمقراطية إلى النُّظم الديمقراطية يجري على شكل موجات متعاقبة، لكلٍّ منها سياقها الزمني والجغرافي، ودينامياتها السببيّة، وأنماطها، وخصائصها، ومتغيّراتها الدولية. وفي هذا السياق، يؤكّد هنتنغتون أنّ عمليّات التحوّل لا تنتظم خطّيّاً، بل تتولّد عند «عتباتٍ حرجة» تُطلق على أثرها «كرة الثلج» أو «الدومينو»، بما يفضي إلى توسّع عددي – معياري في حالات الانتقال، يعقبه دعمٌ مؤسّسي يَحكُم إعادة وضبط التوازنات السياسية. واستئناساً بهذا الإطار التفسيري، يمكن مقاربة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية – أو مشروع «حلّ الدولتين» – بوصفه مساراً عرف ثلاث موجاتٍ متتابعة، احتكمت كلٌّ منها إلى شروطٍ بنيوية ومكانية مخصوصة، وأنتجت تراكماً معياريّاً متزايداً في شرعنة هذا الحلّ وإسناده المؤسّسي.
تتبدّى «الموجة الأولى» بين عامَي 1988 و1995 في أفقٍ دوليّ مطبوع بثنائيّةٍ قطبيّةٍ كانت آيلةً إلى الانحسار، حيث كانت توازنات القوى وقواعد اللعبة السياسية تُعاد صياغتها وترتيبها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. رافقت ذلك الانتفاضة الفلسطينية الأولى سنة 1987. وبعد عام من الانتفاضة تم الإعلان عن «الاستقلال الفلسطيني» في عام 1988. ومن الممكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة الحدث المؤسِّس الذي استتبع طيفاً واسعاً من الاعترافات – غالبيّتها من العالمَين العربي والإسلامي، ودول عدم الانحياز، وأفريقيا، والكتلة الشرقية، مع حضورٍ لاتينيّ محدود – في حين ظلّ الغرب الأوروبي والولايات المتحدة خارج معادلة الاعتراف. وبرزت «اتفاقية أوسلو» عام 1993 بوصفها «العتبة الحرجة» لهذه الموجة؛ إذ خفّضت سقف المطالب إلى ترتيبات «سلطةٍ ذاتية» من دون حسمٍ نهائيّ لمسألة الدولة. وعلى الرغم من أنّ هذه المرحلة راكمت شرعيّةً تمثيليّةً مرتفعة ورأسمالاً رمزيّاً إنسانيّاً وشعبيّاً للقضيّة الفلسطينية، فإن أثرها الحقيقي بقي محدوداً بفعل بنية النظام الدولي آنذاك وتوزيع موارد القوة فيه، بينما أبقى الاعتراف -على سعته الجغرافية خارج الغرب – أقرب إلى ترسيخ المشروعيّة والتمثيلية منه إلى إنتاج أدوات إكراهية قادرة على إعادة ضبط الوقائع على الأرض.
وفي السياق ذاته، اتسمت «الموجة الثانية» بين عامي 2009 و2014 بتموضعها في نظامٍ دوليّ أحاديّ القطبية، تُهيمن عليه الولايات المتحدة عقب عقدٍ من تفكّك الاتحاد السوفياتي، وبانبعاث ديناميّات سياسية متدرّجة لنشوء مراكزَ إقليمية صاعدة. ومن الممكن تحديد انطلاقة هذه الموجة مع ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى «دولة مراقب غير عضو» في عام 2012، واعتبارها نقطةَ ارتكازٍ مؤسّسيةً حفّزت أثر «كرة الثلج» / «الدومينو»، فاندفعت من الدوائر التقليدية في أفريقيا والعالم الإسلامي والكتلة الشرقية إلى اعترافات لاتينيّة متتابعة بين عامَي 2009 و2011 – من البرازيل والأرجنتين وبيرو والإكوادور والأوروغواي وهندوراس وتشيلي وغيرها – موسعة نطاق اتساع الطيف الجغرافي إلى القارة الأميركية الجنوبية. وعلى المستوى التحليلي، راكمت هذه الموجة شرعيّةً رمزيّة معزَّزة عبر تحويل الاعتراف من إشارةٍ سياسية إلى نظام حوافز يتكامل مع الأدوات القانونية والاقتصادية، بما خفّض «تكلفة الانضمام» لدولٍ متحفِّظة، وفتح مساراتٍ لتوسيع القاعدة الاعترافية، مما شجع بقية الدول إلى ركوب عربة الاعتراف بالتاريخ الفلسطيني. وقد تمثّلت «العتبة الحرِجة» النوعيّة في هذه الموجة باعتراف دولة السويد عام 2014، بوصفها أول اختراقٍ داخل الغرب الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويشير إلى انتقالٍ تدريجي في مركز الثقل من الاعترافات الهامشية إلى اعترافٍ يمتلك وزناً معياريّاً ومؤسّسيّاً أقوى داخل المنظومة الأطلسية.
وقد تَجَسَّدَ هذا الانتقال في «الموجة الثالثة» بين عامَي 2014 و2025 عندما تحرك الاعتراف بـ«حلّ الدولتين» من الأطراف إلى مركزه الغربي ضمن سياقٍ بنيوي للنظام الدولي يتراجع فيه نمط الأحادية القطبية لصالح تعدُّديةٍ قطبية قيد التشكل، وعلى خلفيّةٍ صراعية كثّفتها حرب إبادة غزة الأخيرة. ففي أعقاب الاعتراف السويدي عام 2014 تَفعَّل أثر «الدومينو» داخل أوروبا الغربية نفسها، فتتابعت اعترافات دولٍ مثل آيرلندا، وإسبانيا، والنرويج، ثم أرمينيا وسلوفينيا، قبل أن تبلغ العملية «عتبتها الحرجة» مع حرب إبادة غزة الأخيرة التي أعقبها «إعلان نيويورك» في 30 يوليو (تموز) 2025 بقيادة سعودية – فرنسية. ومثّل انخراطُ فرنسا – بوصفها قوةً دائمة العضوية في مجلس الأمن – تحوّلاً نوعيّاً رفع التكلفة السياسية لعدم الالتحاق بالموجة، وأطلق «كرة ثلج» وُسِّعت بين 21 و22 سبتمبر (أيلول) عام 2025 لتشمل أستراليا وكندا والبرتغال عبر منصّات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة. وتضاعف الوزن النوعي لكرة الثلج بانضمام المملكة المتحدة بما تحمله من رمزية تاريخية في تأسيس دولة إسرائيل، وعضويةٍ دائمة في مجلس الأمن. وبهذا، أصبح إجماعُ القوى الدائمة العضوية على الاعتراف – باستثناء الولايات المتحدة – واقعاً مُكرَّساً يبدّل هيكل الحوافز ويقرّب الاعتراف من حيّز الإلزام المعياري بشكل أعمق. وفي هذا السياق، تنبغي الإشارة إلى دور السياسة الخارجية السعودية التي كان لها دور كبير في بناء توافقات متعددة المسارات داخل أوروبا. بل يمكن القول إن شعلة الدبلوماسيّة السعوديّة كانت قد أسهمت في إذابة كرة الثلج، التي هوت من قمة جبال الألب الفرنسيّة لتتدحرج على خريطة أوروبا كلِّها، وتجرف معها مسار الاعتراف من الأطراف إلى قلب القارة الأطلسية. وأثمرت هذه الجهود الدبلوماسية السعودية عن بلورة إطار عقلاني مرجعي للتفاوض، ومعيار ضابط يحكم مداولات الأطراف الدولية يمكن أن ينهض عليه تفاعل اللاعبين في الساحة الدولية، بعيداً عن صخب الشعارات الحنجورية، والخطابات العاطفية والانفعالية.
وقد تميَّزت هذه المرحلة بانتقالٍ نوعي في «مركز الثقل الدولي» من الجنوب والشرق نحو أوروبا الغربية، بما رفع حصيلة الدول المعترِفة من نحو 150 إلى 157 دولة، أي إلى كتلةٍ تمتلك وزناً راجحاً ومؤسسيّاً مضاعفاً بحكم إسهامها التاريخي في نشأة دولة إسرائيل، علاوة على تمتّعها بموارد قوة مادية ورمزية معتبرة في النظام الدولي. وقد أفضى تحرّك «الدومينو» داخل كتلٍ ذات أوزان حرجة كفرنسا وبريطانيا إلى إكساب القضية الفلسطينية وزناً سياسيّاً ورمزيّاً وأخلاقيّاً غير مسبوق؛ إذ لا يُقاس الأثر بعدد الدول فحسب، بل بهويّة الفاعلين وموقعهم في هرم القوة، وقدرتهم على صناعة القرارات الدولية. ومع كل اعترافٍ غربي من دولةٍ كبرى، واتّساع عدد الدول المعترفة في النطاق جغرافيّاً، تتدنّى «مخاطر تكلفة الانضمام» سياسيّاً للدول المتردّدة، فتنتقل من هامش الحياد إلى تيّار الإجماع، مدفوعةً بحوافز رمزيّة وماديّة. وتتعاظم قابليّة هذه الحوافز للتفعيل كلّما تُرجمت إلى ترتيباتٍ أمميّة وقانونيّة واقتصاديّة تُحوِّل الاعتراف من دلالة رمزية ومعياريّة أو أخلاقية، إلى أداة ضبطٍ سلوكيّ إكراهي أو تشجيعي على مستوى النظام الدولي.
وفي الواقع، تُشير ديناميّات حركة التاريخ إلى ميلٍ متزايد نحو «عقلنة» المقاربة السياسية والقانونيّة والأخلاقية للقضيّة الفلسطينيّة. غير أنّ تحويل هذا الميل إلى أثرٍ مُلزِم يظلّ مشروطاً بتبلور سلطةٍ مركزيّة موحَّدة في الداخل الفلسطيني تحتكر الاستخدام المشروع للقوّة وفق منطق الدولة الحديثة. وهذا الأمر يقتضي توحيد مراكز القرار والولاية القانونيّة في إطارٍ مؤسّسيّ واحد، وإنهاء مظاهر الانقسام التي تُزوِّد المتردّدين بمسوّغاتٍ مقنعة لعدم الاعتراف. ويُفسِّر هذا الشرط المؤسّسي إجماعَ الدول الداعمة لـ«حلّ الدولتين» على استبعاد «حماس» من ترتيبات أي حكومة مقبلة، وتفكيكاً لحجّةٍ خطابية يوظّفها نتنياهو دائماً لتبرير الامتناع عن الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة. كما يبقى المسار مُثقَلاً بحزمة تفاوضيّة مؤجّلة – في مقدّمتها وضع القدس، وأزمة اللاجئين، وترسيم الحدود، ومستقبل الاستيطان، وتعريف شكل الدولة المقبلة – وكلّها تستلزم هندسةَ تسوياتٍ تدريجيّة تُزاوج بين مقتضيات الشرعيّة الدوليّة، ومتطلّبات الأمن، والحَوْكمة السياسية الرشيدة. وعلى الضفّة المقابلة، يقتضي ترسيخ هذا المسار تعظيم تمثيل الأصوات الإسرائيلية العقلانيّة المؤيّدة لـ«حلّ الدولتَين»؛ إذ تُفصح مسوح جامعة تل أبيب عن تراجع نسبة التأييد لدى اليهود الإسرائيليين (غير العرب) من نحو 42 في المائة في سبتمبر عام 2020 إلى قرابة 21 في المائة عقب أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأوّل)، وهو انخفاضٌ يناهز النصف تقريباً.
وعلى الصعيد الدولي، لا يُمثّل اعترافُ واشنطن بالدولة الفلسطينية مجرّد إضافةٍ رقمية إلى رصيد الاعترافات، بل يُعيدُ معايرةَ هيكليّة الحوافز والفرص في النظام العالمي عبر رفع تكلفة عدم الاعتراف من مستوى رمزي إلى تكلفةٍ سياسية وقانونية ملموسة على سلوك الفاعلين الآخرين الممتنعين عن هذا الاعتراف. كما يمنحُ الشرعيةَ الفلسطينية سنداً معياريّاً مضاعفاً داخل المنظومة الأطلسية، والتكتلات الدولية العابرة للحدود المتعددة الأطراف. ورغم تباين السياقات، فمن المحتمل أن تتعاظم قابليةُ تحقّق الاعتراف – على اختلاف السيناريوهات – عندما تتكوّن بنيةُ التفاعل التفاوضي من إدارةٍ ديمقراطية في الولايات المتحدة وحكومةٍ إسرائيلية، يساريةٍ أو يمينيةٍ، معتدلة تتسم بقدرٍ أعلى من البراغماتية؛ كما يغدو قبولُ الإدارة الأميركية الحالية مرجَّحاً – ولو على نحوٍ ضعيف – إذا تبدّلت قواعد اللعبة السياسية وربما هوية بعض اللاعبين. وعليه، قد يُشكّل الاعتراف الأميركي محطةَ ختامٍ للموجة الثالثة، أو ربما يفتح مساراً جديداً نحو موجةٍ رابعة تُحوّل الاعتراف من دلالة أخلاقية ورمزية إلى أداةِ إلزامٍ مُقنَّنة تُحفّز ترتيباتٍ تنفيذية قابلة للقياس (أممية، وقانونية، واقتصادية) وتُقوّي قابلية «حلّ الدولتين» للتطبيق، بوصفه الخيار الأكثر عقلانيةً وكفاءةً في حسابات الفاعلين المحليين والدوليين. بل لعل هذا الاعتراف قد يكون إيذاناً ومبشراً بـ«نهاية التاريخ» لمشروع الدولة الفلسطينيّة.