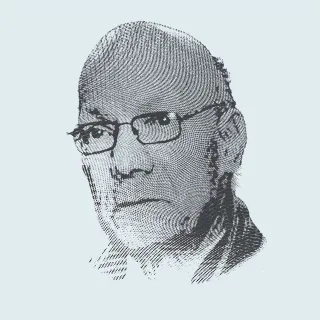حين نتحدث في هذه الأيام عن ثقافتنا العربية؛ ما المعنى الذي نؤديه بهذه العبارة؟ وعلى أي أساس نعتبر نشاطنا الثقافي الراهن في كل أقطارنا نشاطاً مشتركاً، أو جزءاً من كل، وامتداداً لثقافتنا الموروثة، وإضافة جديدة حية تنتمي للماضي، وتواصل التقدم والنمو في الحاضر والمستقبل؟
والسؤال بعبارات أوضح، هل نسمي إنتاجنا الثقافي في جميع أقطارنا ثقافة عربية، لأنه ينتسب لهذه الأقطار التي تجمع بينها العروبة؟ أم أننا في هذه التسمية نتحدث قبل كل شيء عن اللغة التي نستخدمها في إنتاج هذه الثقافة التي يعرفها معظمنا بأدبها، خصوصاً بشعرها، قبل أن يعرفها بأي فن أو فكر آخر؟
وهل تكون اللغة المستخدمة في الإنتاج الثقافي كافية وحدها ليكون كل ما تستخدم فيه ثقافة واحدة؟
لا أظن أن اللغة وحدها تكفي. لأن الثقافة صورة لشخصية أصحابها، فهي تاريخ، وفكر، ونشاط حي، وانتماء. ونحن نعرف مثلاً أن الفرنكفونية جامعة لغوية لشعوب مختلفة؛ أوروبيين، وكنديين، وأفارقة، يمارسون نشاطهم الثقافي بالفرنسية، لكن ثقافة الناطقين بالفرنسية في سويسرا سويسرية، وفي كندا كندية، وفي السنغال سنغالية. وكذلك يقال عن الناطقين بالإنجليزية في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أستراليا، وفي نيجيريا. وعن ثقافة الناطقين بالإسبانية في كولومبيا، وتشيلي، والأرجنتين.
**********
ثم إن الثقافة العربية عصور متوالية بدأت في القرون التي سبقت ظهور الإسلام، واستمرت إلى هذا العصر الذي نعيش فيه. ولا شك في أنها تطورت في هذه العصور الماضية، وكانت لها في كل عصر صورة تختلف قليلاً أو كثيراً عما سبقها ولحقها من صور تتفق في أصول تجمعها، ويتميز كل منها بما ينسبها لعصرها.
ولو عدنا إلى العصور الأولى التي نشأت فيها الثقافة العربية، لرأينا كيف تطورت اللغة ذاتها، وتحولت من صورة إلى صورة في اللهجات التي اختلفت وتعددت حتى استطاعت لهجة قريش – بما أتيح لها في مجتمع مكة من أسباب – أن تتغلب على غيرها بما نظمه فيها الشعراء من قصائد عدّها العرب تراثاً مشتركاً، وكتبوها كما يقول المؤرخون بماء الذهب وعلّقوها في الكعبة، ثم ظهر الإسلام فأصبحت لهجة قريش هي لغة الثقافة العربية كلها، ولا تزال إلى اليوم رغم ما عرفته من تطورات وتحولات في الشعر والنثر، خصوصاً في العصر الحديث.
والذي نقوله عن تطور الثقافة العربية من عصر لآخر وما تتميز به في كل عصر نقوله عما عرفته من تحولات وتميزت به في البلاد التي استوطنتها، وتأثرت في كل بلد منها بطبيعته، وموقعه، ومجتمعه، ونظمه المختلفة، وثقافته المحلية الموروثة من تاريخه السابق على دخوله في العروبة والإسلام.
الشعر الجاهلي يختلف اختلافاً واضحاً عن الشعر العباسي، وهذا الشعر العباسي يختلف عن الشعر الأندلسي. الجاهليون تفننوا في وصف الخيل، وجعلوا الوقوف على الأطلال مطلعاً يلتزمونه في شعرهم لأنهم كانوا بدواً ينزلون ويرحلون، ويتذكرون الأحبة والمنازل التي يخيمون فيها فيشعرون بالحنين وتغلبهم الدموع. وفي بغداد حيث لم يكن بدو ولم تكن أطلال، كان أبو نواس يشرب ويطرب، ويتغزل ويتبذل، ويسخر من الطلل والواقفين عليه، رغم أن له مطالع في بعض قصائده تدل على أن الطلل له في شعره وفي الشعر العربي عامة مكان لا يستطيع شاعر أن ينكره.
**********
فإذا كانت الثقافة العربية في عصورها الماضية تختلف من عصر لعصر، فهي في تلك العصور تختلف كثيراً عما صارت إليه في هذا العصر الحديث الذي عرفت فيه فنوناً وعلوماً لم تعرفها طوال العصور الماضية، فضلاً عما مرت به من تطورات وتحولات نشأت مما تعرضت له البلاد العربية في العصر الحديث من أحداث، ودخلته من تجارب اختلفت من بلد إلى بلد آخر، وكان لها في كل بلد تأثير خاص تميزت به ثقافته عن ثقافة سواه من الأقطار التي أصبحت كلها دولاً مستقلة لكل منها نظمه وقوانينه وثقافته التي ينتمي بها للعروبة، وإن كانت لها سماتها الخاصة.
كل البلاد العربية تأثرت في هذا العصر بالثقافة الغربية، لكن الثقافة الفرنسية التي كان لها تأثير قوي في بلاد المغرب العربي، غير الثقافة الإنجليزية التي أثرت في المشرق الذي تأثر أيضاً بالثقافة الفرنسية، فضلاً عن الظروف العامة التي اختلفت هنا وهناك، وعن ردود الفعل والنتائج التي صارت بها الثقافة العربية الحديثة صوراً متعددة تنتمي كلها لأصول مشتركة، لكنها تتميز في كل بلد بسمات خاصة، ليس بالعوامل الأجنبية وحدها؛ بل أيضاً بالعوامل المحلية التي اختلفت بها ثقافة الجزائريين العربية عن ثقافة أشقائهم في تونس وفي المغرب. اللغة الفرنسية في الجزائر لم تكن لغة المستعمرين الفرنسيين وحدهم؛ بل صارت أيضاً لغة الشارع الجزائري، لأن الفرنسيين انفردوا بالجزائر مائة وثلاثين سنة استولوا فيها على كل المرافق، وفرضوا لغتهم، وشجعوا مئات الآلاف من الباحثين عن الثروة في فرنسا على الهجرة وامتلاك الأراضي في الجزائر التي عدّوها جزءاً من وطنهم. وقد وصل عدد هؤلاء المهاجرين في السنوات التي سبقت استقلال الجزائر إلى مليوني ومائتي ألف رحل معظمهم بعد الاستقلال، ونجح الجزائريون في إحياء لغتهم العربية في التعليم والإدارة، وفي إنتاجهم الأدبي الذي أصبحت العربية فيه هي الأساس، وتراجعت الفرنسية، لتصير رافداً من روافده. ثم إن هناك لغة أخرى غير الفرنسية ربما كان لها تأثيرها في ثقافة الجزائريين العربية وثقافة غيرهم من شعوب المغرب العربي، وهي الأمازيغية التي كان يتكلم بها المغاربة القدماء قبل أن يدخلوا في العروبة والإسلام. وهي لا تزال إلى اليوم لغة مستعملة في مناطق مختلفة في الجزائر والمغرب؛ ومثلها اللغة الكردية في العراق والنوبية في مصر والسودان.
*********
هذا التراث الحافل بأطواره وتحولاته وعصوره المتوالية ومواطنه المتعددة، هو ما نحتاج للإحاطة به واستيعابه وامتلاكه، لكي تكون ثقافتنا الحديثة ثقافة عربية بحق نسهم فيها جميعاً بما حصّلناه في الماضي والحاضر. وهذا ما لا نستطيع أن نحققه إذا مارس كل قطر من أقطارنا نشاطه الثقافي في داخل حدوده، وإنما يتحقق بنا جميعاً حين يصبح نشاطنا الثقافي حواراً متصلاً بيننا. ونحن إذن في حاجة لسياسات، وخطط، ومنابر، وأدوات تمكننا من أن نتحاور مع أنفسنا ومع العالم.
نريد أن نبني ثقافة عربية حديثة؛ لن تكون مجرد تعبير عن شخصيتنا، بل هي أول شرط لظهور هذه الشخصية وإثبات وجودها وفرضه.